الانتصار الأمريكى!
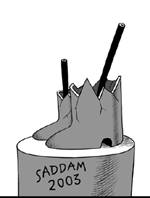
«أسألك، يا سيدي، ماذا يفعل الجيش الأمريكي في العراق؟.. لقد انتهت قصة صدام منذ ثلاث سنوات» - الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في حديث مع مايك والاس في برنامج (60 دقيقة) 13 أغسطس 2006 في مدينة الفلوجة المدمرة، وسط أبنيتها الصفراء الشاحبة التي قوضتها المدفعية الأمريكية في الهجومين الكبيرين في هذه الحرب الممتدة (الهجوم المجهض في مارس 2004 ثم عملية الفجر الدموية في نوفمبر التالي) خلف خطوط أكياس الرمل العملاقة والجدران الكونكريتية والأسلاك الشائكة التي تحيط المعسكر الأمريكي الصغير هناك، جلست في درعي الواقي وخوذتي العسكرية وفكرت بجورج اف كينان. ليس الدبلوماسي الأمريكي الكهل المهيب، ليس «أبا القارة» ذا الثامنة والتسعين من العمر الذي استمع في خريف 2002وهو في دار رعاية في واشنطن، إلي طبول الحرب تقرع، فنطق بالنبوءة المذكورة أعلاه. بل كنت أفكر بالدبلوماسي الشاب والنابه والطموح كينان الذي حدق في أواخر العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي علي أوروبا المحطمة من تالين وبرلين وبراغ واستقرأ نذُر الصراع الدولي القادم.
وقد حدث أنه في مخبأ «مركز العمليات المدنية العسكرية» المعروف باسم Moc-C في وسط الفلوجة، حيث بضع عشرات من المارينز وحفنة من المدنيين يقبعون في مخبأ تحت مبني مدمر بدون ماء جار أو طعام طازج، التقيت بروح كينان متلبسة بشخص موظف شاب من وزارة الخارجية الأمريكية: وهو شاب نابه وجريء قضي أياما بطولها يذرع شوارع الفلوجة في درعه الواقي وخوذته مع مرافقيه المترددين يقابل مسئولين عراقيين محليين ويكتب برقيات سريعة إلي بغداد أو واشنطن لإبلاغ رؤسائه بحقيقة ما يجري علي الأرض، حتي لو لم يكونوا راغبين في سماعها. كان هذا الدبلوماسي الشاب مطلعا وذكيا ولا يتعب. وبينما كنت أراقبه يمزح ويجادل الشيوخ والسياسيين والتكنوقراط المحليين الذين كانوا يلتقون معه، رغما عن إرادتهم، في المخبأ الأمريكي - جاء إلي ذهني كينان الشاب الذي لا يقهر في سنوات تلك الحروب وفكرت كيف، إذا كان للجهد الأمريكي في العراق أن «ينجح»، فلن يجعل ذلك ممكنا إلا شباب ذو همة وبعد نظر مثل خليفته الروحي هذا.
هذا كان في أكتوبر 2005 عشية الاستفتاء علي الدستور العراقي المقترح وكان علي أن أذهب إلي الفلوجة، قلب محافظة الأنبار الثائرة لأري ما إذا كان يمكن للسنة أن يجمعوا من القوة السياسية ما يسقطه. ففي مادة أصر عليها الأكراد، مادة تمثل العملية السياسية التي صممها الأمريكان والتي كان هدفها توحيد البلاد ولكن بدلا من ذلك ساعدت علي تمزيقها، كان يمكن رفض الدستور إذا عارضه، ثلثا الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الثماني عشرة. وخلال أول استفتاء ما بعد صدام في شهر يناير الماضي كان الاستعراض التليفزيوني المضخم «التلويح بالأصابع البنفسجية» والتي أصبحت ربما الأكثر بروزا من كثير من «فواصل التغيير» التي وعدت بها هذه الحرب الطويلة، كان السنة قد قاطعوا تلك الانتخابات. ولكن هذه المرة أسفرت الجهود الهرقلية في الإقناع والمفاوضات التي قام بها السفير الأمريكي عن قبول معظم السنة التصويت. ولكن الذي جعلهم يقبلون - أو هذا ما كان شائعا - هو الفرصة لإسقاط الدستور والعملية السياسية برمتها.
وهكذا بينما جلست بعد منتصف الليل عشية التصويت، أكتب في دفتري في المخبأ الأمريكي علي الضوء الشاحب، وبينما كان الدبلوماسي الشاب يشرح لي خبايا السياسة في المدينة المدمرة، سرّني أن أراه فجأة يميل نحوي وبعد أن تلفت حذرا حوله، همس لي «هل تعلم؟ سوف تفاجأ غدا مفاجأة كبيرة. الكل سوف يفاجأ. الناس هنا لن يذهبوا للتصويت فقط وإنما عدد كبير من الناس سوف يقولون نعم للدستور».
شعرت بالصدمة. إن دعم السنة الدستور سيكون نقلة هائلة للجهد الأمريكي في العراق، نقلة إيجابية حيث سيكون معني ذلك أنه رغم تصاعد العنف علي الأرض خاصة هنا في الأنبار فإن العراق في الواقع كان يتحرك باتجاه إجماع سياسي نوعا ما. سيكون معني ذلك أنه تحت المشهد الدموي للقنابل الانتحارية والاغتيالات والعبوات الناسفة، هناك فكرة مشتركة حول السياسات وأن نوعا من التوافق بدأ في الطفو علي السطح. هذا يعني أن ما بدأ يظهر كعملية سياسية خاطئة ساهمت في تقسيم العراقيين كانت في واقعها وسطا لتجميعهم معا. هذا يعني أنه لا يزال هناك أمل.
وقد اعتبرت كلمات الدبلوماسي الشاب بمثابة حكمة قيمة من أمريكي يعرف الأرض أفضل من غيره وقد احتفظت بها في رأسي لساعات تالية بينما كنت أتجول بين مراكز الاقتراع في مدينة الأنقاض استمع للفلوجيين الذين عبروا عن غضبهم من الأمريكان و«الإيرانيين» (كما كانوا يسمون السياسيين الشيعة ) وعن كراهيتهم للدستور الذي يعتقدون أنه يقسم وبالتالي يدمر العراق. وقد راجعت في ذهني كلمات الدبلوماسي ذلك المساء لاسيما أني بعد يوم مضن من المقابلات لم ألتق بعراقي واحد يعترف بأنه سوف يصوت للدستور. وفكرت في كلماته مرة أخري بعد عدة أيام حين تأكد انه في محافظة الأنبار - حيث أسرّني اكثر الأمريكان اطلاعا ونباهة وخبرة بأنه يعتقد بكل جوارحه أن عددا كبيرا جدا من الناس سوف يصوتون بنعم - اتضح أن 97 % من كل مائة شخص في الأنبار صوتوا بلا. مع كل اتصالاته واجتهاده وكل همته ونباهته، وفي أكثر المواضيع أهمية وحساسية في السياسة علي الأرض كان مخطئا بشكل كارثي.
«تعرف متي أين تبدأ ولكن لن تعرف أبدا أين تنتهي» كان جورج كينان البالغ من العمر ثمانية وتسعين عاما والجالس في دار رعاية في واشنطن حين بدأت الحرب، يعرف من ثمانية عقود من الخبرة أن التركيز يجب أن يكون علي مشكلة ما نعرف وما لا نعرف، وأنت تعرف رغم أنك قضيت أيامًا محبطة لا نهاية لها تتحدث إلي العراقيين وتحشدهم وتجادلهم، أنه في بلاد مزقتها حرب وحشية معقدة فإن أولئك العراقيين هم شريحة من قطاع صغير من السكان: العراقيون الذين يرغبون في المخاطرة في حياتهم للقاء والحديث مع الأمريكان. بتعبير آخر، في أحيان كثيرة هم العراقيون الذين يعتمدون علي الأمريكان ليس في كسب رزقهم فحسب وإنما في وجودهم. وأنت تعرف أن المعلومات التي يعرفها هؤلاء العراقيون تكون - مثلهم - محدودة، وما يقولونه هو بحد ذاته منتقي، إلي حد ما، لإرضاء المتحاور معهم. ولكن رغم أنك تعرف أن معلوماتك تأتي من شريحة صغيرة ومتحيزة حول السياسة العراقية والحياة العراقية، فإن مئات من هذه الأحاديث خلال تلك الأيام الحالكة الطويلة تقودك إلي التفكير، ويجب أن تقودك إلي ذلك، بأنك أصبحت تفهم ما يدور في هذا المكان العنيف والمعقد إلي حد كبير. وتبدأ في الاعتقاد بأنك تعرف. وغالبا، حتي بالنسبة للأشياء الأكبر، أنت لا تعرف.
وحين يسافر هذا التيار الثمين من ومضات المعرفة من أولئك الذين يجمعونها من الأرض الخطرة المليئة بالشظايا «إلي القيادة العليا» في مكاتب واشنطن لاتخاذ قرارات استنادا إلي هذه المعلومات، فإن مشكلة ما نعرفه حقا تتفاقم، وتكتسب تعقيدا شرسا. يجب علي صناع السياسة الذين يلقون نظرة مختلسة علي عالم معتم من خلال طرف ثان وثالث ورابع، أن يتعلموا الشك المتواضع الصبور، وبخلافه حين يجابههم واقع غامض لا يحبونه، يشيحون بوجوههم متجاهلين المشهد المريب المتغير، مكرهين أعينهم علي التحديق بعناد في نور أيديولوجيتهم. وحين يعجزون عن رؤية الوضوح يفرضونه. تأمل، مثلا، هذه الكلمات لدونالد رامسفيلد وهو يتحدث عن حرب العراق في 9 نوفمبر، بعد يومين من الانتخابات وبعد يوم من إقالته:
«من الواضح أن العمليات القتالية الرئيسية كانت ناجحة نجاحا هائلا. من الواضح انه في المرحلة الثانية من هذه الحرب، لم تكن الأمور جيدة أو سريعة بما فيه الكفاية».
مثل هذه التحليلات لم تكن نادرة بين مسئولي البنتاجون المدنيين مثل دوف زخايم، مساعد سابق لرامسفيلد حين قال لمحاور تليفزيوني ذلك المساء:
«سوف يجادل الناس في الجزء الثاني، المرحلة الثانية لما جري في العراق. ولكن لا يستطيع إلا القليل أن ينكروا أن النصر العسكري في المرحلة الأولي كان نجاحا كبيرا».
بعد ثلاث سنوات وثمانية أشهر من حرب العراق، يري وزير الدفاع وحلفاؤه في العراق حربين وليست حربا واحدة. إحداهما هي «حرب العراق الحقيقية» أو «النجاح الكبير» الذي لا ينكره سوي القلة، الحرب التي «رحب بالجنود الأمريكان كمحررين» طبقا للنبوءة الشهيرة التي يصر عليها ديك تشيني نائب الرئيس وكانت حقيقية «حقيقية في إطار أن المعركة ضد نظام صدام حسين وقواته مرت سريعا» و«بهذا الإطار» يري وزير الدفاع السابق ونائب الرئيس حرب أمريكا الراهنة في العراق حربا «ناجحة نجاحا هائلا» مؤثرة وسريعة استمرت بضعة أسابيع وقادت إلي نصر حاسم. ثم.. ماذا؟ حسنا، مهما يكن ما نحن فيه الآن، مرحلة ثانية، «مرحلة ما بعد الحرب» (كما يسميها بوب وودوارد أحيانا) والتي استمرت ثلاث سنوات ونصفًا وتستمر. في الأولي: الحرب الحقيقية الناجحة مات فيها 140 أمريكيا وفي مرحلة ما بعد الحرب مات 2700 أمريكي - والعدد يتصاعد. ما يحدث الآن في العراق في الواقع ليس حربا علي الإطلاق وإنما مرحلة، لا حرب، شيء بلا اسم، بلا مضمون، بلا خطة.
ومن يسعي إلي فهم أي لغز أصبحت حرب العراق - كيف حدث أن هذا العدد الكبير من المسئولين ذوي الدراية والخبرة والذكاء اجتمعوا علي أخطاء هائلة ومؤثرة وفوق كل شيء واضحة، أخطاء كان الكثير في الحكومة يعرفون في وقتها أنها أخطاء - انظروا إلي ما وراء الظاهر وهو خطاب بسيط لتبرير الذات واتبعوه إلي حيث يؤدي: حرب الخيال التي قرر المسئولون الكبار شنها في ربيع وصيف عام 2002 والتي تشبثوا بصورتها حتي بعد أن اتخذ الواقع نقلة حادة ومنفصلة. في حرب الخيال تلك، كان لابد للنصر أن يكون حاسما وكاسحا بقوة عسكرية رهيبة.. تكفي لمسح عار 11 سبتمبر وإعادة تشكيل الخطر في العالم. في كتابه (حالة إنكار) يسرد وودوارد كيف سأل مايكل جيرسون وكان في حينها كاتب خطابات بوش، هنري كيسنجر عن سبب تأييده لحرب العراق:
«لأن أفغانستان لم تكن تكفي» هذا ما رد به كيسنجر مضيفا أنه في الصراع مع الإسلام الأصولي، هم يريدون إذلالنا. «ونحتاج إلي إذلالهم» كان من الضروري للرد الأمريكي علي 11/9 أن يكون أكثر من رد متوازن - علي نطاق أوسع من مجرد غزو أفغانستان والإطاحة بطالبان. كان من الضروري القيام بشيء آخر. حرب العراق كانت ضرورية لإرسال تلك الرسالة «من أجل توضيح أننا لن نعيش في العالم الذي يريدونه لنا».
ورغم أن أي شخص يعرف خطاب كيسنجر (الواقعي) حول القوة والمصداقية لن يدهش من أقواله هذه، ولكن جيرسون وهو مثالي عميق التدين وكان يؤلف معظم نغمات بوش حول «إنهاء الطغيان» و«تخليص العالم من الشر» شعر بالإحباط قليلا وعلق فيما بعد أن كيسنجر «يري العراق بمضمون سياسات القوة فحسب. لا توجد مثالية. يبدو انه لا يتوافق مع هدف بوش في نشر الديمقراطية».
كان جيرسون بطبيعة الحال مؤلف ما أصبح يعرف باسم (عقيدة بوش)، وهي تسبيح المحافظين الجدد للديمقراطية التي تقضي بأن «المصالح الواقعية لأمريكا سوف تخدم الآن بالإخلاص للمثل الأمريكية خاصة الديمقراطية» وآخرون في الإدارة علي أية حال كانوا «يتفقون» مع واقعية كيسنجر العارية: دونالد رامسفيلد مثلا الذي يصوره رون ساسكند في كتابه (عقيدة الواحد بالمائة) يتصارع مع المسئولين الآخرين في ربيع 2002 للتعامل مع تحذيرات مخيفة متعددة لهجمات وشيكة علي الولايات المتحدة.
كل هذه التقارير ساعدت علي إذكاء إحساس رامسفيلد بلا جدوي قدرة أمريكا لإيقاف انتشار الأسلحة التدميرية وإبعادها عن أيدي الإرهابيين. وتلك اللاجدوي كانت الوقود الذي أشعل خطط غزو العراق بأسرع وقت ممكن.
وقد ردد رامسفيلد أفكار تشيني حول كيف سيساعد «رد فعلنا» علي تشكيل سلوك - حتي لو لم يكن لدينا أدلة - في لقاء لم يذع مع رؤساء دفاع الناتو في بروكسل بتاريخ 6 يونيو. وحسب موجز لخطابه، قال الوزير للمجتمعين بأن «الحصول علي دليل قاطع لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا للتحرك».
كان جوهر غزو العراق الأساسي، طبقا لأولئك الذي حضروا إيجازات مجلس الأمن القومي حول الخليج في هذه الفترة، هو كيفية جعل صدام حسين أمثولة أو نموذجًا توضيحيا لتعديل سلوك أي حاكم لديه ميل للحصول علي أسلحة تدميرية أو الاستهانة بسلطة الولايات المتحدة.
يمكن تسمية الضفيرة المزركشة بالأسباب والمبررات التي قادت لحرب العراق «جديلة الواقعية» ورغم أن شكل التبرير قد يبدو لجريسون بعيدا من «بناء الديمقراطية» و«إنهاء الطغيان» كبعد «سياسة القوة» عن «المثالية» فإن المسافة بينهما كانت إيهاما يعتمد علي وضوح أيديولوجي لم يوجد قط. في الواقع جدلت وتقاطعت سلاسل المبررات لتؤدي بشكل متصلب إلي رغبة مشتركة للقيام بإجراء معين - مجابهة صدام حسين والعراق - والتي كانت موضوع اجتماع مجلس الأمن القومي في يناير 2001 وقد دفعت هذه الخطة مرة ثانية إلي رأس جدول الأعمال بواسطة مسئولي وزارة الدفاع في أول اجتماع لوزارة الحرب بعد هجمات 11 سبتمبر.
يصف وودوارد تقريرا صادق عليه بول وولفوفتز، وكان في حينها نائب وزير الدفاع، يقصد به إبراز «أنواع الأفكار والاستراتيجية المطلوبة للتعامل مع كارثة بحجم 11 سبتمبر» بعد الهجمات، تحدث وولفوفتز الي صديقه كريستوفر ديموث رئيس معهد انتربرايز الأمريكي الذي جمع مجموعة من المفكرين والأكاديميين في سلسلة من المناقشات أصبحت تعرف باسم «بليتشلي 2» (بعد الحرب العالمية الثانية أنشئت مؤسسة فكرية تضم علماء رياضيات وخبراء شفرة في منتزه بليتشلي Bletchley Park). ومن هذه المناقشات كما يخبرنا وودوارد كتب ديموث مسودة تقرير مؤثر بعنوان «دلتا الارهاب» والذي اختتم باستنتاج، بتعبير المؤلف بأن «الولايات المتحدة مستعدة لخوض معركة ضد الإسلام الأصولي تستغرق جيلين».
كان التحليل العام أن مصر والعربية السعودية حيث ينتمي إليهما معظم الخاطفين كانتا المفتاح ولكن المشاكل فيهما غير واضحة. إيران أكثر أهمية حيث إنهم أقاموا فعلا حكومة راديكالية «ولكن من الصعب أيضا معرفة من أين تؤتي إيران».
ولكن صدام حسين يختلف، فهو اضعف وأكثر هشاشة. وقال ديموث إنهم توصلوا إلي أن «البعثية هي شكل عربي من أشكال الفاشية المرتبطة بالعراق».
«وتوصلنا إلي أن المواجهة مع صدام لا يمكن تفاديها. إنه خطر يتصاعد وفعال ولا يمكن تجنبه. واتفقنا أن علي صدام أن يترك المشهد قبل معالجة المشكلة» كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لتغيير المنطقة.
وطبقا لوودوارد، كان لهذا التقرير تأثير قوي علي الرئيس بوش مما أدي به إلي التركيز علي «المرض الخبيث» في الشرق الأوسط - والحاجة إلي اقتطاعه بشن هجوم علي العراق، لن يخدم فقط - في سرعته الكاسحة والمدمرة - كمثال حي لردع أي شخص يفكر في تهديد الولايات المتحدة، ولكن للبدء في عملية «التغيير الديمقراطي» الذي سوف ينتشر بسرعة في المنطقة. كان يمكن التكهن بهذا التفكير الجيوبولتيكي الذي ينفخ الحياة في «نظرية الدومينو الديمقراطية» قبل الحرب، وقد كتبت قبل خمسة أشهر من عبور الدبابات الأمريكية حدود العراق:
خلف فكرة أن التدخل الأمريكي في العراق سوف يجعل منه «أول ديمقراطية عربية» كما يقول نائب وزير الدفاع بول وولفوفتز، يكمن مشروع شديد الطموح. إنه يري عراق ما بعد صدام حسين - مجتمعا علمانيا، متوسط الطبقة ومتحضر وغني بالبترول - سوف يحل محل أوتوقراطية العربية السعودية كحليف أساسي لأمريكا في الخليج العربي مما يسمح بانسحاب قوات الولايات المتحدة من المملكة. وسوف يخدم وجود جيش أمريكي منتصر في العراق كمحفز قوي لتحويل إيران إلي جارة معتدلة حيث يسرع تحول تلك البلاد من حكم الملالي باتجاه نهج اكثر اعتدالا. ومثل هذا التطور في طهران سوف يؤدي إلي سحب الدعم الإيراني لحزب الله والجماعات المتطرفة الأخري وهكذا يعزل سوريا ويقلل الضغط علي إسرائيل. والقضاء علي المتطرفين علي حدود إسرائيل الشمالية وداخل الضفة الغربية وغزة سوف ينهي ياسر عرفات ويؤدي بالتالي إلي حل افضل للمشكلة العربية الإسرائيلية.
هذه رؤية مغرقة في الخيال: شاملة وتنبؤية وإنجيلية. وفي طموحها غريبة عن تواضع سياسة الاحتواء وأيديولوجيا قوة الوضع الراهن التي كانت جوهر الاستراتيجية الأمريكية لنصف قرن. إنها تصبو لإعادة تشكيل العالم، ولتقديم جواب سياسي لتهديد سياسي. إنها تمثل خطوة كبري علي طريق الرؤيا القصوي للرئيس بوش عن «انتصار الحرية علي كل أعدائها الأبديين».
إنها تمثل أيضا مقامرة تأخذ بالألباب لأن النصر في العراق إذا كان سيحقق ما هو متوقع منه - أي «إذلال» قوات الإسلام الأصولي وإعادة الهيبة والمصداقية الأمريكية، ويصلح لتقديم «أمثولة» لردع هجمات أي دولة مارقة قد تهدد الولايات المتحدة، إما مباشرة أو بدعم الإرهابيين بأسلحة الدمار الشامل، وتغيير الشرق الأوسط وذلك بإطلاق «تسونامي ديمقراطي» يهدر من طهران إلي غزة - إذا كانت حرب العراق ستحقق كل ذلك، فلابد أن يكون النصر سريعا وحاسما وكاسحا.
وذلك لن يتحقق إلا بجيش رامسفيلد الجديد - قوات سريعة خفيفة وقليلة تسندها قوة نارية كاسحة تدار بدقة بواسطة تكنولوجيا عالية مع القليل جدا من (البساطيل علي الأرض)، أو هذا ما اعتقده المخططون. سيكون النصر سريعا وصادما وفي اشهر قليلة، سوف يخرج الأمريكان إلا حفنة منهم: ولن يبقي من آثار الحرب سوي «الأمثولة» والتأثيرات علي الدول المجاورة. القوة العسكرية الكاسحة سوف تطلق العملية ولكن ما أن تبدأ فإن التغيير سوف يتدحرج إلي الأمام محمولا علي أكتاف قوات من نفس «الثورة الديمقراطية» المثيرة التي تفجرت في شوارع براغ وبودابست وبرلين الشرقية قبل اكثر من عقد من السنين وبالتأكيد في شوارع كابول في السنة الماضية. كان هناك رؤية إنجيلية للخلاص الجيوبوليتيكي.
وهكذا أغفلت حرب الخيال كل تعقيدات وتناقضات التاريخ والسياسة في مجتمع مزقته الحرب والعنف، في رؤية أيديولوجية لمستقبل مثالي. ولهذا لا ندهش أن صانعي هذه الحرب وهم يواجهون حلكة الواقع، كانوا اشد الكارهين للتخلي عن هذه الرؤية. ومنذ أول ليلة مثيرة من الصدمة والرعب وقد نقلتها بحماسة منقطعة النظير شبكات التليفزيون الأمريكية، كان لحرب العراق تاريخان: تاريخ الحرب ذاتها وتاريخ الإدراك الأمريكي لها. بمرور الشهور وتزايد عدد الهجمات في العراق، اتسعت الفجوة بين التاريخين. وأخيرا بالنسبة لمعظم الأمريكيين، كانت حرب الخيال - التي بنتها الحماسة القومية والعنجهية الأيديولوجية ومصطلحات الإدارة حول «نشر الديمقراطية» و«الترحيب بالحلوي والورود» وثم «ازلام صدام» و«فواصل تاريخية» وأخيرا «الاستمرار في النهج» ورفض «التخلي والهرب» - بدأت الحرب تحت ضغط حوالي ثلاثة آلاف قتيل أمريكي وربما مائة ألف أو أكثر من القتلي العراقيين، تخلي الطريق للواقع الكئيب.
انتخابات 7 نوفمبر 2006 تؤشر لحظة تخلي حرب الخيال عن موقعها للحرب علي الأرض حين أجبر المسئولون في كل الحكومة الأمريكية، وليس اقلهم الرئيس نفسه - علي الاعتراف بالواقع الذي اكتشفه الشعب الأمريكي قبل شهور أو سنوات. لقد رفع الغطاء الأيديولوجي. ومجموعات الدراسات منهمكون في بحوثهم. وبدأ الأمريكان يعرفون ما لا يعرفونه. وإذا سئل أي أمريكي ذلك السؤال البسيط الذي وجهه رئيس إيران أحمدي نجاد وهو يبتسم لمايك ولاس في أغسطس الماضي «أسألك يا سيدي ماذا يفعل الجيش الأمريكي داخل العراق؟» فكم من الأمريكان يستطيع أن يجيب جوابا واضحا ومقنعا؟
وفيما تستمر الحرب وتتساقط البدائل وتتصاعد أعداد قتلي الأمريكان والعراقيين، يبدو أننا نعلم الأقل والأقل، لاسيما إجابة سؤال «أين سننتهي؟» وهكذا نصل إلي لحظتنا الشافية الراهنة - لحظة «الحلول» التي يأتي بها الإقرار بعد ثلاث سنوات ونصف بأننا لا نملك أية فكرة حول كيفية «إنهاء» المرحلة الثانية. هذه مشكلة جيمس بيكر ومجموعة دراسة العراق الآن وأيضا «فريق المراجعة الاستراتيجية» العسكري ورؤساء اللجان الديمقراطية في الكونجرس الذين سوف يقدمون لرئيس يعترف بأنه ظن «بأننا سوف ننجح» في الانتخابات، الأفكار الجديدة التي يتعهد بالترحيب بها. علي أية حال ينتقل النقاش الآن بسرعة إلي الموازين الجيوبولتيكية لوزن اقتراحات: انسحاب جزئي أو مؤتمرات إقليمية والاتصال بالجماعات وغير ذلك، والحقيقة أنه ولا واحد من هذه المقترحات وحدها أو معا، سوف ينهي هذه الحرب قريبا.
وتجدر ملاحظة أن كينان نفسه بعد أن تنبأ بأننا لن نعرف أين سننتهي في العراق، عاش ليري قبل موته في سن 101 في مارس الماضي، خطل رأيه الذي قاله كحقيقة مسلم بها «تعرف أين تبدأ» لأنه حين اعتبرت الحرب قد انتهت بناء علي صور انتصار مصنوعة بعناية: تماثيل الدكتاتور تهشم والرئيس يختال بقوة علي حاملة طائرات، قد تلاشت واضمحلت من الأذهان إلي مستقبل مجهول («قرار للرئيس المقبل» كما قال الرئيس بوش قبل الانتخابات) كما ذابت بدايات الحرب واختفي المبرر الأصلي في اضطراب حالك من المعلومات المتغيرة والأيديولوجية المثيرة للجدل والمزاعم المتناقضة، وقد أغرقتها من كل الجوانب دماء تلال من القتلي.
ومن بين هذا الاضطراب العظيم كيف يمكن للمرء أن يعرف «كيف بدأنا» في العراق؟ هل كانت البداية في التوجيه الرئاسي للأمن القومي المعنونة «العراق: الأهداف والاستراتيجية» وهو بيان في غاية السرية حول الهدف الأمريكي يقصد به إرشاد كل الوزارات ووكالات الحكومة وقد وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في 29 أغسطس 2002 .
«غاية الولايات الأمريكية: تحرير العراق من اجل القضاء علي أسلحة الدمار الشامل، وأساليب إطلاقها والبرامج المتعلقة بها، من اجل منع إفلات العراق من الاحتواء ليصبح تهديدا اكثر خطورة للمنطقة وما وراءها.
إنهاء التهديد العراقي لجيرانه، إيقاف قمع الحكومة لشعبها، قطع علاقات العراق ورعايته للإرهاب الدولي، للحفاظ علي وحدة العراق وأراضيه ولتحرير شعب العراق من الطغيان ومساعدتهم في إقامة مجتمع يعتمد علي الاعتدال والتعددية والديمقراطية.
الأهداف: اتباع الإدارة لسياسة تقليل فرص هجمات بأسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في الميدان وحلفائنا وأصدقائنا. لتقليل خطر القلاقل الإقليمية. لردع إيران وسوريا من مساعدة العراق ولتقليل انقطاعات البترول عن السوق العالمية».
ويفترض أن هذه الوثيقة السرية التي كشفها بوب وودوارد، هي ابسط وأوضح بيان والأقل أيديولوجية لما كان المسئولون الأمريكان يعتقدون أن البلاد التي يتولون شئونها سوف تحققه في الحرب القادمة. الكلمات الآن لها طابع حزين وأثري كما لو خطت علي «رق اصفر» ولا يقدر علي كشف شفرتها سوي مؤرخ خبير في عادات وتقاليد مكان وزمان بعيدين. ماذا يمكن أن نقول الآن حين ننظر إلي العراق في نوفمبر 2006 حول هذه الأهداف والغايات من حرب العراق؟
أسلحة الدمار الشامل.. اختفت، ربما قبل خمسة عشر عاما، وقد دمر غيابها الولايات المتحدة وقوتها - القوة التي تنشرها يوميا والتي تعتمد علي سلطة الكلمات والخطاب وليس علي قوة السلاح فحسب - وكان هذا التدمير اكثر إيلاما مما لو كانت موجودة فعلا. وفيما كانت إدارة بوش علي اقتناع تام بأن العراق يملك علي الأقل أسلحة كيمائية وبيولوجية، فإن مسئولي الإدارة، مثل الشرطي الذي يحاول أن يلصق التهمة برجل يؤمن بذنبه ولكن لا يملك دليلا علي ذلك، ضخموا الدليل بشكل مهول وبهذا الفعل - وحتي برفضهم السماح لمفتشي الأمم المتحدة فحص الدليل وتقييمه - فقد أضاعوا مصداقية الولايات المتحدة، ومصداقية وكالاتها الاستخباراتية ودعم الحرب والسياسة الأمريكية وسط الأمريكيين والمسلمين والعالم كله.
وقد أضاعت الحرب «احتواء» العراق الذي لم يكن تهديدا لأحد قبل الحرب سوي في مخيلة صناع السياسة، فالبلاد اليوم هي تهديد للمنطقة بتدفق الجهاديين من القوي السنية المجاورة إلي الأنبار وبغداد وتدفق رجال المخابرات الإيرانية في الجنوب الشيعي يزداد يوما بعد يوم مما يهدد بأسوأ مستقبل ممكن: مشهد مضطرب وحالك لحرب طائفية إقليمية، تلوح الآن في الأفق كنتيجة محتملة لاقتتال يتصاعد.
ورغم الاتهامات لصدام حسين بجرائم قتل جماعية وأن هناك حكومة تقبع في المنطقة الخضراء، فمن الصعب المجادلة بأن «قمع» العراقيين خارج تلك المنطقة صار اقل. فكل يوم يموت من العراقيين حوالي مائة أو اكثر بسبب العنف في حرب أهلية معقدة متصاعدة. السنة يهاجمون الشيعة بقنابل من كل الأصناف - انتحارية ومفخخات من سيارات وعجلات ودراجات بخارية - ويحافظون علي هذا الرعب بمستويات غير مسبوقة وغير متخيلة. في الأشهر الستة الماضية وحدها شهدت بغداد 488 تفجيرا إرهابيا، بمعدل ثلاثة في اليوم.
قادة الشيعة يردون بفرق الموت المتغلغلة في ميليشيات حزبية وغالبا مرتبطة بوزارة الداخلية والشرطة العراقية وقد عذبوا واغتالوا آلاف السنة. وفي حين يذهب العراقيون للتسوق أو للصلاة، تفجر أجسامهم إلي أشلاء. وحين يقودون سياراتهم في المدن في وضح النهار ينتزعون من سياراتهم من قبل مسلحين في نقاط التفتيش ثم يذبحونهم أو يقتلونهم بالرصاص. وحين يجلسون في بيوتهم ليلا يخطفهم رجال الشرطة أو من يرتدون أزياء الجيش حيث يملأون بهم شاحنات ويحملونهم بعيدا إلي أماكن سرية للتعذيب والإعدام، ليعثر الناس في الأيام التالية علي جثثهم موثقة الأيدي معصوبة الأعين في المزارع أو علي جوانب الطرقات. وهذه الجثث وقد فحصها مسئولون من الأمم المتحدة في مشرحة بغداد:
تحمل علامات تعذيب شديد بضمنها جروح حوامض وحرائق باستخدام مواد كيمائية وسلخ الجلود وكسر العظام (الظهر والأيدي والسيقان) وقلع العيون والأسنان وثقوب تسببت فيها آلات ثقب كهربائية أو مسامير.
ويقول خبير في التعذيب تابع للأمم المتحدة «إن الوضع من السوء بحيث إن الكثير من الناس يقولون إنه أسوأ بكثير مما كان في أيام صدام حسين» ومن الصعب إدراك مستوي القتل طبقا للأرقام الرسمية التي تنشرها الأمم المتحدة التي تقلل من الحقيقة، فقد ذكر أن 6599 عراقيا قتل في يوليو وأغسطس وحدهما. وتقديرات أعداد المدنيين العراقيين الذين قتلوا أثناء الحرب يتراوح بين الرقم المعتدل 52 ألفًا في موقع «حساب القتلي العراقيين» علي الانترنيت وبين 655 ألفًا كما ذكرته كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، في حين أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أن المجموع الكلي هو 15 ألفا.
أما بالنسبة لعلاقات العراق بالإرهاب الدولي، فعلينا أن ننظر في التقرير الرسمي لوكالات الاستخبارات الأمريكية الصادر في أبريل 2006 بأن جهاد العراق ينتج جيلا جديدا من الإرهابيين وقادتهم وان الصراع في العراق اصبح «قبلة الجهاد» التي تنتج مشاعر العداء العميق للتدخل الأمريكي في العالم الإسلامي وترعي تجنيد أنصار لحركة الجهاد العالمية. وتخشي إدارة بوش أن تعاون العراق المحتمل مع الجماعات الإرهابية، وهو محض حدس، قد تحول منذ سقوط صدام إلي واقع فظيع.
وفي نفس الوقت «وحدة العراق ووحدة أراضيه» أصبحت القضية المركزية، حيث اندلعت حرب طائفية ويجري تطهير عرقي وطائفي في كل المدن والمناطق وقد اصدر الشيعة قانونا، في وجه المعارضة السنية الشديدة، يجعل من الممكن إقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب وهو ذروة العملية السياسية التي قاطعها السنة منذ الانتخاب الأول وتذكي هذه القضية فتيل الصراع الطائفي.
والسؤال المحوري حول كيفية توزيع السلطة والموارد في العراق وكيف يكون شكل البلاد، وهي أسئلة من المفروض أن تجيب عليها بطريقة سلمية المؤسسات السياسية في «أول ديمقراطية عربية» لكنها أصبحت القضية السياسية الحساسة التي تفرق بين الكرد والسنة وبين السنة والشيعة وكما تقسم التحالفات السياسية داخل الكيان الواحد أيضا. ورئيس الوزراء نوري المالكي قائد «حكومة الوحدة» الذي يطلب منه بوش باستمرار أن «يحل الميليشيات» هو في واقع الحال يعتمد في وجوده السياسي علي مقتدي الصدر صاحب وقائد اكبر ميليشيا: جيش المهدي. وبالتأكيد فإن اقوي اثنتين من الميليشيات تتبعان اثنين من أقوي الأحزاب في البرلمان.
وتزداد صراعات «حكومة الوحدة» ذاتها داخل المنطقة الخضراء مما تبدو مثل صدي عقيم للحرب الوحشية الدائرة خارج جدران المنطقة. والآن يدعو الكثيرون علانية لتقسيم العراق - بضمنهم سياسيون أمريكان بارزون مثل سيناتور جوزف بايدن من ولاية ديلاوير وهو الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. بسبب اليأس عن إيجاد «حل» حتي لو كان وهميا للحرب.. أي شيء يسمح للأمريكان بالانسحاب بدون الاضطرار للاعتراف بالهزيمة.
مشكلة كينان في عدم معرفة «أين تنتهي» تبدأ، كما كان يعرف جيدا، علي الأرض ولكنها لا تنتهي هناك. المعلومات المتحصلة من بشر مخلصين ولكن عرضة للخطأ تسافر من أماكن مثل الفلوجة عبر البرقيات والبريد الإلكتروني والرسائل الشفاهية إلي ملجأ المنطقة الخضراء الشاسعة بمساحة 4 أميال مربعة، بحوائطها الواقية ضد الانفجار المتكونة من ست طبقات من الكونكريت وأكياس الرمال والأسلاك الشائكة، ومن هناك إلي المتاهة الهائلة لمكاتب الأمن القومي في واشنطن والي الأعلي من خلال آلاف الموظفين المتنافسين في مكاتب ووكالات حتي تصل إلي الناس الذين في قمة الأهرام المؤسساتية: الناس الذين كما يقال «يصنعون القرارات». وفي أفضل الإدارات تنظيما يوجد بين أولئك الذين علي الأرض يستمعون ويتعلمون وأولئك الذين في مكاتبهم يجادلون ويقررون، كمّ هائل من «الضجيج» البيروقراطي. وهذه الإدارة للأسف، كما يتبين من الكثير من حكايات صنع قراراتها حول الحرب، لم تكن أفضل الإدارات تنظيما. وبالتأكيد رغم أن المسئولين الذين في قمتها موهوبون وذوو خبرة، يبدو وكأنهم تعاونوا عمدا، لأسباب ذاتية أو طموح العنجهية الأيديولوجية في إصابة أنفسهم بالعمي الجماعي.
تأملوا، علي سبيل المثال، هذا النقاش المدهش والنمطي في البيت الأبيض في أبريل 2003 حين كان احتلال العراق ماضيا كأول خطوة حيوية من خطة الرئيس بوش «لتغيير الشرق الأوسط». القوات الأمريكية في بغداد ولكن العاصمة تحيطها موجة من النهب والفوضي وقوات الجنرال تومي فرانكس تتفرج. وكان الرجل المسئول في الاحتلال الجنرال (المتقاعد) جاي جارنر قد وصل لتوه «في البلاد». جاء وزير الخارجية كولن باول إلي المكتب البيضاوي لمناقشة الاحتلال مع الرئيس وقد انضمت إليهم كوندليزا رايس التي كانت في حينها مستشارة الأمن القومي. يقول وودوارد في كتابه، إن باول بدأ حديثه بإثارة «قضية وحدة القيادة» في العراق.
قال باول للرئيس: هناك سلسلة قيادة. جارنر مسئول أمام رامسفيلد، وفرانكس مسئول أيضا امام رامسفيلد.
بدت الدهشة علي الرئيس.
قالت رايس: هذا ليس صحيحا.. هذا ليس صحيحا.
وفكر باول بأن رايس قد تكون في بعض الأحيان متأكدة مما تقوله ولكنه أيضا كان علي يقين من انه كان مصيبا. فأصر علي القول: بل هو صحيح.
قاطعه بوش قائلا وهو يأخذ جانب رايس:«لحظة.. هذا لا يبدو صحيحا».
ونهضت رايس إلي مكتبها للتأكد. حين عادت. ظن باول أنه رأي نظرة خذلان تلوح علي وجهها. قالت:هذا صحيح.
ماذا كان سيقول كينان، الدبلوماسي المحترف عن مثل هذا النقاش بين رئيس ووزير خارجية ومستشارة أمن قومي لو امتد به العمر ليقرأه؟ كان سيفهم المعني فورا، في حين أن الرئيس ومستشارته للأمن القومي لم يدركا ذلك. مما أدي إلي أن يوضح باول للرئيس توضيحا صبورا مفصلا:
عليك أن تفهم أن لديك سلسلتين من القيادة وليس لديك مشرف مشترك في الميدان، مما يعني أن أية مشكلة تحدث بينهم هناك في الميدان، إذا لم يحلوها بأنفسهم لابد من الرجوع إلي مكان واحد لحلها وذلك هو البنتاجون. ليس مجلس الأمن القومي ولا وزارة الخارجية بل البنتاجون.
بل هناك سؤال أقسي وأمرّ حول الحرب في العراق - كيف يمكن للمسئولين الأمريكان أن يتخذوا باستمرار وبشكل متكرر مثل هذه القرارات الغبية بدون سند من مشورة جيدة بدءا من انعدام التخطيط لما بعد الحرب؟ - وبذرة الجواب تكمن في غرفة اللعب في المكتب البيضاوي، وفي حقيقة أن ثلثي الموظفين غير قادرين علي فهم النص. في كتاب وودوارد، رايس التي كانت حينذاك المسئولة الرسمية عن التنسيق بين إدارات الأمن القومي للحكومة الأمريكية وجدت أن ما يقال هو «مناقشة نظرية نوعا ما» بحيث أغفلت حقيقة أنها هي ومجلس الأمن القومي الذي ترأسه لم يكن لهما تأثير في صنع القرار في حرب العراق - وأن ذلك حدث لصالح مسئول واحد هو وزير الدفاع رامسفيلد الذي، إذا صدقنا رواية وودوارد، كان لا يكلف نفسه في الرد علي نداءاتها الهاتفية.
ونستمع مرة أخري للتوضيح الصبور من باول - الذي كان دوره كما يبدو في إدارة بوش مثل دور كاساندرا، وهو يتلفظ بنبوءات يتم تجاهلها مع ثبوت صدقها فيما بعد - وقد سمح باول لوودوارد (وليس الرئيس هذه المرة ) ليطلع علي رأيه من أن «البنتاجون لن يحل الصراعات لأن وولفوفتز وفايث يلعبان ألعابهما الصغيرة الخاصة وأجندتهما لدفع الجلبي إلي الواجهة».
يستحضر اسم أحمد الجلبي، مدير الجوقة الذكي والجذاب والمخاتل في مجتمع العراقيين في المنفي، ذكريات كوارث مضت، ومن وجهة نظر البنتاجون، أحلاما تهشمت: الملك الذي لم يتوج. انه شخصية لا تقاوم وقد لعب في الكواليس دور شرير الشاشة في ميلودراما الحرب العراقية مع اهتمام خاص بدوره في تقديم معلومات إلي العديد من المتشوقين لسماعها في مختلف أقسام الإدارة الأمريكية، مما أدي إلي تدعيم قضية امتلاك العراق لترسانة من أسلحة الدمار الشامل. وفي الواقع كان للجلبي دور اكثر تأثيرا، باعتباره الحاكم القادم المختار من البنتاجون حلا للسؤال المحرج حول ماذا نفعل في مرحلة ما بعد الحرب.
كانت هناك تناقضات واضحة في صلب حرب الخيال: حلم دونالد رامسفيلد بتقديم «الأمثولة» بعد حرب سريعة ونصر كاسح، لم تكن تتضمن احتلالاً ممتدا - علي العكس، كان وزير الدفاع يناهض بشدة في العلن اية فكرة باستخدام قواته من أجل «بناء أمة». كانت رؤية رامسفيلد هي حرب يكون فيها نصر سريع وانسحاب سريع. أما وولفوفتز والمحافظون الجدد الآخرون في البنتاجون فقد كانوا يرون في مخيلتهم «تغييرا ديمقراطيا» ثورة اجتماعية شاملة تجتث أوتوقراطية يحكمها البعث مع الجيش الذي يقوده البعث وأجهزة الأمن وتحويل المجتمع إلي نظام ديمقراطي فاعل بدون مساهمة مسئولين بعثيين سابقين.
كيف كان يمكن حل هذا التناقض؟ الجواب بالنسبة للبنتاجون كان يتركز في كلمة واحدة: الجلبي. ويقول المؤلف جيمس رايزن في كتابه (حالة حرب):
فيما يتعلق الأمر بالعراق، كان البنتاجون يعتقد أن الرصاصة الفضية التي يحتاجها من أجل تفادي أوحال قضية بناء أمة - هي حكومة مؤقتة في المنفي تتمركز حول الجلبي يمكن إقامتها ثم إيصالها إلي بغداد بعد الغزو.
وقد بدت هذه الخطة توفيقية مثالية: الجلبي كان شيعيا كمعظم العراقيين ولكنه كان أيضا علمانيا عاش في الغرب لمدة خمسين سنة تقريبا وكان صديقا لكثير من المسئولين المدنيين في البنتاجون. ولكن يا للأسف! كانت هناك مشكلة واحدة فقط: المثالي الذي في البيت الأبيض «كان مصرا علي ألا تظهر الولايات المتحدة وكأنها تضع إصبعها علي الميزان» في الديمقراطية العراقية الناشئة. والجلبي رغم كل شعبيته الكبيرة في البنتاجون ومكتب نائب الرئيس لن ينصب رئيسا للعراق.
ويلاحظ رايزن «رغم أن التزام بوش بالديمقراطية كان مبعث ثناء ولكن تدخله الطائش لم يكن حقا الجواب علي سؤال تخطيط ما بعد الحرب» ويضيف:
حالما قمع بوش خطط البنتاجون، فشلت الإدارة في تطوير أي بديل مقبول.. بدلا من ذلك، فحالما أدرك البنتاجون أن الرئيس لم يكن سيسمح لهم بتنصيب الجلبي، رفعت قيادة البنتاجون يدها. بعد الجلبي.. لم تكن هناك خطة (ب).
ويصف مسئول في البيت الأبيض لم يفصح عن اسمه لرايزن آثار لوريل وهاردي داخل الحكومة التي نتجت عن التزام الرئيس بفكرة الانتخابات الديمقراطية في العراق:
«جزء من سبب غياب التخطيط لعراق ما بعد صدام هو أن وزارة الخارجية كانت تقول إذا غزيتم يجب أن تكون لكم خطة ما بعد الحرب، ووزارة الدفاع تقول: كلا.. لا حاجة. يمكن إقامة حكومة في المنفي يرأسها الجلبي. كانت خطة وزارة الدفاع غبية ولكن علي الأقل كان لديهم خطة. ولكن إذا لم تكن لديك خطة وإذا لم تجعل البنتاجون يتعاون مع الخارجية في الخروج بخطة ما، فأنت في النهاية تذهب إلي الحرب بدون خطة».
علي كل من يود أن يجيب علي سؤال «كيف بدأنا» في العراق أن يواجه حقيقة أن الولايات المتحدة، أقوي دولة في العالم، غزت العراق بدون أية فكرة معينة ومحددة حول ما ستفعله هناك ثم توضيح ما تفعله. وفي كتابه يرفض وودوارد إغواء الجلبي ولكن ليس إغراء الميلودراما، وبدلا من ذلك يختار بتوقيت سياسي دقيق أن يصور دونالد رامسفيلد في دور الفتوة «مبروم الشوارب» وهو اختيار يبدو أن الجلّ الأعظم من الجماهير، في أعقاب الانتخابات وسقوط الوزير الفوري من السلطة، كانت تستمتع به. والوزير المشاكس والمتكبر والمغرور كان يبدو راغبا تماما في لعب دوره في هذه القصة حيث يجهز نفسه للسقوط المتوقع بقضاء ساعات علي المنبر أمام الصحفيين وكاميرات التليفزيون خلال وبعد الغزو.
يعطي سقوط رامسفيلد دفعة ورواجا لكتاب وودوارد. وبدون شك فإن هذا سوف يسعد القراء الذين شعروا وهم يقرأون الكتاب بالغضب الجارف للفشل غير المعقول في التخطيط والتنفيذ وهم يكافئون أنفسهم بموجة من الرضي حين يحصل المحتوم من إلقاء الشخص المعني من النافذة ورغم أن هذا حدث خارج إطار الكتاب ولكنه كان متوقعا من مضمونه. ورغم أن كتاب (حالة إنكار) قد نشر قبل شهر من الانتخابات، ولكن المقابلات التي أجراها المؤلف في التليفزيون المحلي وأساليب الدعاية الأخري كانت مؤشرات علي أن السكاكين قد خرجت من أغمادها وشحذت وأن أيام الوزير أصبحت معدودة.
ورغم جاذبية رامسفيلد كشرير الأحداث فإن قصة كارثة حرب العراق تنبع بنفس القدر من أفعال رئيس عنيد وصعب المراس وقليل الخبرة استطاع أن يشكل بمساعدة نائب الرئيس القوي عملية حكم مشوهة إلي حد مثير. وبما أن وودوارد يهتم بشخصيات اللاعبين والمنافسة بينهم اكثر من مكاتب وتسلسل المسئولية في الحكومة، فهو يشير إلي هذه العملية بشكل عام بتعبير «روتين الحكومة Interagency كما في قوله «قالت رايس إن روتين الحكومة كان مقطوعا» وتعني به جهاز الحكم الذي وضع بقانون الأمن القومي لعام 1947 والذي جمع مسئولي الأمن القومي الرئيسيين في الحكومة: وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والمدعي العام ومدير الاستخبارات القومية وكثيرين غيرهم في مجلس الأمن القومي وأعطي الرئيس مساعدا خاصا لشئون الأمن القومي (يسمي عادة مستشار الأمن القومي) وموظفين لإدارتهم والتنسيق بينهم والتحكم فيهم. ورغم أن مجلس الأمن القومي و«لجان المساعدين» وأي هيئات فرعية أخري ترتبط بوزارات الحكومة المختلفة في مستويات اقل فمن المفترض أن توجيه المعلومات والسياسة تصعد حسب التسلسل الإداري إلي الرئيس وان قراراته تهبط الهم بنفس التسلسل. وقد تعمق رون ساسكند في دراسة العمل الداخلي لإدارة بوش منذ كشفه الأول حول كارل روف وجون ديلوليو في 2003 وكتابه حول بول اونيل في السنة التالية، يقول إن «روتين الحكومة» لا يخدم فقط إيصال المعلومات والقرارات ولكن أيضا يؤدي وظيفة أساسية أهم.
بالجدية والاجتهاد ومراقبة سلوك الإدارات السابقة في تحديات مماثلة تواجه الولايات المتحدة، تخلق في الواقع نوعا من كبح سلطة الرئيس وامتيازاته.
وهذا بالضبط ما لم يكن بوش يريده خاصة بعد 11 سبتمبر، ولكونه شديد الشك بالبيروقراطية ولرغبته في اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ولقلة صبره مع خبراء البيروقراطية والسياسة أراد الرئيس أن يتحرك، ويقول ساسكند:
بالنسبة لجورج بوش حدث له تطور في هذه الأمور. من رئيس ما قبل 11 سبتمبر الذي لم يكن يعي بشكل كامل الشئون الخارجية ولم يتخذ في ذلك المجال سوي القليل من القرارات المهمة إلي رئيس ما بعد 11 سبتمبر الذي واجه تحديات أمريكا الخارجية بحسم ولد من يقين قائم علي الإيمان الديني والطاقة الذاتية. وفي واقع الأمر لم تختلف عملية صنع القرار كثيرا. فقد كانت القضايا تناقش وغالبا بصخب علي مستوي النواب والمسئولين الكبار ولكن لم تكن القضايا تصعد بشكلها النهائي إلي مكتب الرئيس وإذا حدث ذلك فبعد أن يكون بوش قد اتخذ قراره اعتمادا علي ما يسمي «حدسه» أو «شجاعته».
يميل وودوارد إلي إلقاء اللوم بسبب «سلسلة صنع السياسة المقطوعة» علي قوة الشخصيات المتحلقة حول طاولة الوزارة: سلطة وقسوة رامسفيلد، «المحارب البيروقراطي» الأسطوري، وضعف رايس مع أن وظيفة وهدف منصبها هو تمكين الرئيس من الانتفاع والسيطرة علي البيروقراطية ولكنها كانت في الواقع مسلوبة القوة. ويجادل ساسكند بشكل أكثر إقناعا بأن بوش وتشيني شكلا الحكومة التي يريدانها بالضبط: مركزية وبالغة السرية وقراراتها مباشرة لا تعتمد علي معلومات أو مشورات. يقول ريتشارد ارميتاج النائب السابق لوزير الخارجية لساسكند «لم يكن هناك سلسلة صنع قرار لقطعها من قبل كوندي أو غيرها. لم تكن هناك أية سلسلة منذ البداية. لم يكن بوش يريدها لأي سبب» ويوضح ساسكند السبب في تحليل دقيق للشخصية والقيادة:
من بين عدة أسباب لتحرك الرئيس في هذا الاتجاه، ينبثق واحد من إيمان جورج بوش بيقينه وخاصة، بعد 11 سبتمبر، وحاجته إلي حماية القدرة علي توجيه هذا اليقين في وجه التعقيدات الموجودة. ووجهة نظره حول الصواب والخطأ والأفعال الخيرة ومهاجمة الشر أو نشر «هبة الله» الديمقراطية - كانت تقطع بذلك النوع من التحليلات ذات اللون الرمادي التقليدي التي تشكل العنصر الرئيسي في حمية معظم الرؤساء. إن اليوم التقليدي لهذا الرئيس يبدأ مع قراءة الإنجيل عند الفجر ثم التمارين الرياضية ثم الفطور، ثم إيجاز للأخطار الخارجية والداخلية.. والتحليل المعقد والعميق في مثل هذا الروتين سيكون في كميات هزيلة بعد مرورها في مصفي تشيني ورايس أو قد لا تقدم أبدا.
وقد ضمن هذا الروتين منافع فريدة لبوش. فمع تقليل الناس الذين يطلعون علي قراراته الحقيقية يمكن الحفاظ علي السرية التامة وبهذا يمنع التسرب. والقرارات السريعة - إما تستبق نقاشا مفصلا أو تتجاهله - يمكنها أن تتحرك مباشرة إلي التنفيذ السريع مع التأكيد علي كيفية التنفيذ وليس أسبابه الأكثر تعقيدا.
ما عرفه بوش قبل أو خلال إصدار قرار مهم، يظل سرا لا يفض أختامه إلا مجموعة قليلة: تشيني ورايس وكارد وروف وتينيت ورامسفيلد.
ولبقية الحكومة يظل هذا الإجراء سرا. ويصف ساسكند كيف أن الكثير من أولئك الذين في «مؤسسة السياسة الخارجية» وجدوا أنفسهم «مرتبكين» بسبب النظرة إلي عملية صنع القرار السياسي التقليدية علي أنها غير منتجة وخطرة. والمعلومات التي يمكن أن تبطئ من اتخاذ القرار في الأمور الجريئة والمجازفة مثل حرب العراق، المعلومات والنقاشات - وتوضيح مثلا العوائق الدقيقة التي تواجه «انتقالا ديمقراطيا» يقوم به حفنة من القوات - كان يمكن أن تشل القرار. ورأي بوش هو انه لو كانت قراءة التاريخ والحقائق تقف في طريق تنفيذ قرار جريء إذن لابد من إهمال التاريخ والحقائق. كان منطق بوش هو ان المجازفة بعمل لاشيء، المجازفة بالوضع الراهن كانت تبرر التحرك. وباعتبار الحقائق السيئة علي الأرض - احتمال ان يهاجمنا في المستقبل إرهابي من الشرق الأوسط «الخبيث»، عدم إمكانية القدرة الكاملة علي حماية البلاد منه - الأفضل أن نعانق المجهول، أي أن نتصرف بناء علي فكرة «الفوضي البناءة» وهو مصطلح رائع كان، كما يقول ساسكند:
قد استخدمه العديد من المسئولين الكبار فيما يخص العراق - وهو مصطلح يتفق مع أفكار المحافظين الجدد قبل 11/9 حول الحاجة لوقفة أمريكية جديدة وصلبة غير محدودة، والأفكار النامية التي استفحلت بسرعة بعد الهجمات جعلت كل ما قبل 11/9 يوضع علي الرف كتاريخ يعلوه التراب.
التفكير المتروي الماضي والعتيق القائم علي السبب والنتيجة أو علي سوابق متفق عليها لم يعد مهما مثله مثل الدراسات السياسية المتعمقة، أو الاتفاقات بين الدول، أو ترتيبات طويلة الأمد تحدد المشهد الدولي.
ما يهم كان «حدس» الرئيس لقيادة أمريكا عبر طريق جديد بعد 11/9 نمط من القيادة علي محيط صغير وسري.
أمريكا بلا حدود كان يقودها بشكل مناسب رئيس بلا حدود.
وتعبير «يقودها بشكل مناسب» هو القضية. المعرفة والتاريخ وكل ما يرفد سياسة متروية قد يكبح اتخاذ إجراء ما ولكنه يفعل ذلك بعد وزن وحساب المجازفة. وتجاهلها يجلب الكوارث إلا في حالة صحة الفرضية بأن الفعل الجريء يجعلنا دائما أكثر أمنا وهذا ما أثبتت حرب العراق خطأه.
إذن لن يكون هناك الرئيس الجلبي. ومع سوء الحظ يقول وودوارد إن الرئيس الذي كان يظن نفسه «كالسيوم عمود فقري» الحكومة الأمريكية، بعد أن حرم تنصيب الجلبي، لم يقدم خطة بديلة كما لم يجبر الحكومة التي يقودها علي الموافقة علي غيره. كما لم يفعل رامسفيلد الذي كان يعرف انه يريد نصرا سريعا وانسحابا سريعا. ومن اجل تأكيد هذه النقطة، فبعد وقت قصير من الغزو الأمريكي بعث الوزير مساعده الخاص لاري ديريتا إلي الكويت من اجل توجيه التعليمات للفريق الهزيل والبائس والفقير في العدد والعدة الذي يقوده الجنرال المتقاعد جاي جارنر والذي كان يستعد للطيران إلي بغداد التي تعمها الفوضي من أجل «السيطرة علي الانتقال» وهذا هو «خطاب هيلتون» الذي ألقاه ديريتا كما اقتبسه وودوارد من الكولونيل بول هيوز:
لقد ذهبنا إلي البلقان والبوسنة وكوسوفو ومازلنا فيها.. ومن المحتمل أن نظل في أفغانستان لفترة طويلة لأن وزارة الخارجية لا تستطيع القيام بواجبها بصورة صحيحة. ولأنهم يستمرون في إفشال كل شيء، تنتهي وزارة الدفاع إلي التورط في هذه الأماكن. ونحن لن ندع هذا يحدث في العراق.
ورد الفعل العام كان: ياه! هل يدرك هذا الرجل أن نصف الموجودين في هذه الغرفة هم من وزارة الخارجية؟
ويتذكر هيوز أن ديريتا استمر يقول: «في نهاية أغسطس سنترك 25ألفًا إلي 30 ألف جندي في العراق».
بينما كان ديريتا يقول هذه الكلمات، كانت بغداد والمدن العراقية الرئيسية الأخري علي بعد بضع مئات من الأميال تتعرض لهجمات نهب وسلب لوزارات الحكومة والجامعات والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمصانع - مما سينتج عنه القضاء علي البني التحتية للبلاد ومعه احترام العراقيين للكفاءة الأمريكية. وقد أحاط العنف المنفلت عاصمة العراق والمدن الرئيسية لمدة أسابيع في حين كانت القوات الأمريكية وعددها 140 ألفًا أو أكثر - تجلس في دباباتها تتفرج. وإذا كان تحقيق السلطة السياسية يعتمد علي ضمان احتكار العنف الشرعي، إذن لن يستطيع الأمريكان تحقيق ذلك أبدا في العراق. كان عديد القوات أقل من القدرة علي فرض النظام وبالكاد يوجد شرطة عسكرية. ولم يصدر أحد أمرا باعتقال أو قتل اللصوص أو السيطرة علي الشوارع بشكل ما. وكانت تبدو المقاصد الرسمية للبنتاجون بالضبط كما قال المساعد الخاص لوزير الدفاع: لإخراج كل القوات من العراق ماعدا 25 ألفًا أو ما يقاربها في غضون خمسة أشهر أو اقل.
كيف يمكن السيطرة إذن علي بلاد في حالة فوضي متنامية؟ كانت معظم الوزارات قد نهبت وأحرقت وما كان يطلق عليه حكومة في حينها كانت تتكون من حفنة من مسئولين عراقيين استطاع فريق جارنر الصغير أن يدفعهم إلي العودة للعمل. ومن أجل التوافق مع المقاربة العامة لنصر سريع وانسحاب سريع كان جارنر قد أوجز الرئيس ومستشاريه قبل مغادرة واشنطن بتأكيد خطته بطرد البعثيين الكبار من الحكومة وكذلك استخدام الجيش العراقي لإعادة البناء وللحفاظ علي النظام.
وبعد أسابيع من اللقاء في هيلتون الكويت وصل بول بريمر إلي بغداد للحلول محل جارنر الذي طرد بعد أقل من شهر في العراق. وفي أول يوم كامل لبريمر في البلاد كما يقول وودوارد، هرعت إحدي موظفات جارنر إلي رئيسها الذي أصبح بطة عرجاء ورمت ورقة في يده.
سألته: هل قرأت هذا؟
قال جارنر: كلا. لا اعرف ماذا لديك.
قالت وهي تسلمه وثيقة من صفحتين: إنها سياسة اجتثاث البعث.
الوثيقة كانت «قرار رقم (1) من سلطة التحالف المؤقتة - اجتثاث البعث من المجتمع العراقي» من أجل إزالة كل أعضاء حزب البعث فورا من مناصبهم ويحرم عليهم العمل في وظائف حكومية. وفي كل وزارة سيجري التحقيق الجنائي مع المديرين في المستويات الثلاثة العليا.
قال جارنر: إننا لا نستطيع أن نفعل ذلك.
وكان لايزال يؤيد كما أخبر رامسفيلد «اجتثاثا لطيفا» بطرد البعثي رقم واحد ومديري الموظفين في كل وزارة. وأضاف «هذه مسألة واسعة جدا».
وقد توجه جارنر فورا إلي مكتب بريمر حيث كان قائد الاحتلال الجديد يحاول الاستقرار، وفي طريقه أسرع إلي لقاء رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية والذي نشير إليه هنا باسم تشارلي. وسأله جارنر: «هل قرأت هذا؟».
قال تشارلي: لهذا أنا هنا اليوم. دعنا نذهب للقاء بريمر.
وذهب الرجلان لرؤية بريمر وكانت الساعة الواحدة بعد الظهر وقال جارنر له «جيري.. هذا كثير جدا. اعطنا أنا وتشارلي ساعة وسوف نناقشه ونري حسناته وسيئاته ثم نتصل برامسفيلد ونشذب الأمر قليلا».
قال بريمر: كلا بالتأكيد. هذه تعليماتي وأصر علي تنفيذها.
وحين رأي جارنر الذي سيعود قريبا إلي الوطن انه لا يستطيع التأثير علي بريمر استنجد برجل المخابرات الذي «كان رئيس المحطة في دول شرق أوسطية أخري» سائلا إياه عما سيحدث إذا أصدر الأمر.
قال تشارلي: إذا نفذت هذا، فسوف تدفع ما بين 30 ألفًا و50 ألف بعثي إلي العمل تحت الأرض قبل حلول الليل. سوف تضع 50 ألف واحد في الشارع وتحت الأرض يغلون بالحقد ضد الأمريكان. «وهؤلاء الخمسون ألفًا هم الصفوة الاقوي والاكثر خبرة وكفاءة في كل الميادين.
قال بريمر وهو ينظر اليه: لقد أخبرتكما أن لدي تعليمات وعلي أن أنفذها.
وكما نعرف أن سلسلة القيادة تمر برامسفيلد وهكذا طلبه جارنر هاتفيا وناشده ان يمنع الأمر فقال له هذا - ما سيكون حجر الزاوية في كتاب وودوارد - إن المسألة خرجت من يده.
قال: هذا لم يصدر عن هذا المبني. بل من مكان ما آخر.
وافترض جارنر أنه يقصد البيت الأبيض أو وكالة الأمن القومي أو تشيني. ولكن طبقا لآخرين فإن أمر اجتثاث البعث كان من ابتكار البنتاجون وما قاله رامسفيلد لجارنر من أن الأمر ليس في يده كان من أجل إنهاء المكالمة.
إن مثل هذه الأساليب هي التي ميزت رامسفيلد باعتباره «المحارب البيروقراطي الماهر» الوصف الذي لصق به طوال عمله في الحكومة مثل حكمة هومرية. في الواقع وطبقا لبريمر فقد استلم الاوامر من البنتاجون قبل بضعة أيام ومن دوجلاس فايث نفسه مساعد رامسفيلد لشئون السياسة. وفي رواية بريمر أن فايث أعطاه المسودة وأكد له علي «الأهمية السياسية لهذا القرار».
«علينا أن نبين للعراقيين بأننا جادون في بناء عراق جديد. وهذا يعني أن أدوات صدام القمعية لا مكان لها في هذه الأمة الجديدة».
في اليوم التالي وهو ثاني يوم لبريمر في العراق، سلم جارنر مسودة قرار آخر. ويقول وودوارد انه قرار رقم 2 بحل وزارتي الدفاع والداخلية وكل الجيش العراقي وكل حرس صدام والمنظمات الرديفة الخاصة.
صعق جارنر، فإذا كان قرار الاجتثاث غبيا فهذا كارثة. كان جارنر قد قال للرئيس وكل مجلس الأمن القومي بوضوح ان يخطط لاستخدام الجيش العراقي - وعدده علي الأقل 200 ألف إلي 300 الف - كعمود فقري لإعادة إعمار البلاد ولتوفير الأمن. وكان قد أعطي مرارا تقارير فديوية حول هذه الخطة لكل من رامسفيلد وواشنطن.
وكان كولونيل أمريكي وعدد من ضباط وكالة المخابرات المركزية يجتمعون بانتظام مع ضباط عراقيين من اجل إعادة الجيش. وكانت لديهم قوائم للجنود ووعدوا بدفعات مساعدات مادية طارئة. وطبقا لجارنر «الجيش العراقي السابق كان يقدم إشارات علي انتظار العودة بشكل ما» ومرة أخري هرع جارنر لرؤية بريمر.
وقال جارنر بإصرار: لقد كانت لدينا علي الدوام خطط لإعادة الجيش. وهذه الخطة تأتي مفاجئة أضاعت اشهرا من العمل».
أجاب بريمر: حسنا.. الخطط تتغير. والفكرة أننا لا نريد الجيش القديم وإنما جيشا جديدا تماما.
«جيري.. تستطيع أن تتخلص من جيش في يوم ولكنك ستحتاج إلي سنوات لبناء جيش جديد».
ومرة أخري يخبر بريمر جارنر أن لديه أوامره. وتصل المناقشة إلي نقطة هزلية غير مقصودة حين يأتي ذكر وزارة الداخلية والتي أعلن بريمر أنه يريد إلغاءها أيضا.
قال جارنر: انك لا تستطيع التخلص من وزارة الداخلية
- لماذا؟
- أنت نفسك خطبت أمس وأخبرت الجميع بأهمية الشرطة.
- إنها مهمة فعلا
- كل الشرطة في وزارة الداخلية. إذا أقفلتها سينصرف الجميع إلي بيوتهم هذا اليوم.
ولدي سماع بريمر هذه المعلومة بدت الدهشة عليه - وهو تعبير مشابه بلا شك لتعبير رايس حين علمت هي والرئيس من وزارة الخارجية أن سلطة التحالف المدنية تتلقي اوامرها ليس من البيت الأبيض وإنما من البنتاجون. ولسوء الحظ كان في البنتاجون رؤيتان متصارعتان لشكل الاحتلال في العراق: نصر سريع وانسحاب سريع وهي رؤية رامسفيلد، والرؤية الأيديولوجية الأوسع للمحافظين الجدد وهي التغيير الديمقراطي للمجتمع العراقي وكانت الرؤيتان تتقاطعان بصعوبة لفترة من الوقت في شخص احمد الجلبي الذي كان يبدو انه يحقق الرؤيتين معا. ولكن مع رفع تتويج الجلبي من أجندة الرئيس بوش، كان المسئولون الملتزمون بالرؤية الثانية والذين لهم خط مباشر إلي بريمر كانوا يحولون مغامرة العراق إلي احتلال طويل الأمد وشديد الطموح. وقد استيقظ جارنر في 7 مايو وهو يفكر علي هذا النحو «الولايات المتحدة الآن لديها علي الأقل 350 ألف عدو اكثر من اليوم السباق - الخمسين ألف بعثي وال 300 ألف جندي عاطل «وفي نفس الوقت يحس بالارتياح لأنه استطاع في جهود آخر دقيقة إقناع بريمر لحذف وزارة الداخلية من مسودة القرار حتي تستطيع الشرطة البقاء».
يمكن للمرء أن يدافع عن «اجتثاث البعث» في العراق ويمكن للمرء أن يدافع أيضا عن حل الجيش العراقي ولكن من الصعب أن يدافع المرء عن فكرة أن هذه الإجراءات لم تقف عائقا متناقضا مع خطة البنتاجون للانسحاب ماعدا 30 ألف جندي من العراق خلال بضعة اشهر. لأنه مع حل الجيش العراقي وبطرد كل أعضاء حزب البعث من الوزارات والهيئات الحكومية وبتسريح كل قوات صدام الأمنية - وكل هؤلاء قد تحولوا إلي أعداء أشداء ضد الاحتلال الأمريكي - من كان سيحفظ النظام في العراق؟ ومن كان عليه أن يبني «الجيش الجديد» الذي تحدث عنه بريمر؟
وهذه الأسئلة تطل واضحة وهائلة حتي أن المرء يتصور أنه لا بد أن يكون لها أجوبة وان كانت غير مقنعة. الحقيقة البسيطة هي أن هاتين الخطوتين الخطيرتين - اجتثاث البعث من الحكومة وحل الجيش العراقي - مع قرار بريمر الذي اتخذ أيضا خلال أيامه الأولي بالتقليل من شأن مجموعة السياسيين العراقيين إلي رمز يسمي مجلس الحكم العراقي، قد حول ما كان خطة نصر وانسحاب سريع للبنتاجون إلي احتلال لانهاية له سوف يتضمن بالتأكيد إنشاء جيش عراقي جديد.
لم يحسب حساب المعاني السياسية لقراري الاجتثاث وحل الجيش فقد بدا الأمر للسنة علي أنه إعلان حرب مفتوحة ضدهم مما اقنع الكثيرين بأنهم لا يحاكمون علي معايير السلوك الفردي وإنما لمجرد كونهم أعضاء في جماعة - يحاكمون ليس طبقا لما فعلوه وإنما لما هم عليه. وهذا بحد ذاته يقضي علي الأمل في خلق عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية المستقرة: المعارضة المخلصة: أي المعارضة التي تؤمن بعدالة النظام بحيث تنبذ العنف. وقد قال لي شاب سني في أكتوبر 2003 وكان التمرد قد ازدهر «لقد خلقتم أيها الأمريكان أعداءكم هنا».
من غير المحتمل أن تكون رؤية البنتاجون للانسحاب السريع ستنجح مع بريمر أو بدونه. ما يثير الانتباه علي أية حال، هو أسلوب اتخاذ اشد القرارات أهمية بأكثر الطرق تهورا. فمع السلطة التي كانت في أيدي قلة من المدنيين في البنتاجون الذين لا يعرفون شيئا عن العراق أو المنطقة، تم إقصاء خبرة بقية الحكومة، فيما كان الرئيس وكبار موظفيه يتفرجون.
في خضم الأحداث يبدو أن إدارة بوش قد قلبت معضلة كينان لمعرفة الحقائق رأسا علي عقب: الفشل المنهج في العراق نتج بشكل كبير عن التصميم الإرادي لإقصاء أعضاء الحكومة الذين يعرفون أي شيء عن أولئك الذين يتخذون القرارات. ويقول وودوارد مثلا أن ستيفن هادلي وكان حينها نائب رايس والآن خليفتها.
«علم أولا عن قرارات الاجتثاث وحل الجيش حين أذاعها بريمر علي العراق والعالم. فلم تمر هذه القرارات في الروتين الرسمي وحسب علم هادلي لم يكن هناك موافقة من البيت الأبيض ولم تستشر رايس. لم ترسل المسودة إلي واشنطن أو مجلس الأمن القومي لاتخاذ قرار بها».
وقد عرضت مسودة هذه القرارات علي محامي مجلس الأمن القومي ولكن من أجل إعطاء رأيه القانوني فقط. أما صناع السياسة فلم يروا المسودات ولم تتوفر لهم أية فرصة لقول رأيهم في صواب الفكرة من عدمه أو حتي للإشارة إلي إنها تختلف اختلافا جذريا عن الخطط السابقة التي أبلغت للرئيس.
أما بالنسبة للجيش فإن الرجال الذين كانوا مسئولين عن تأمين العراق والذي سيتأثر عملهم بقرارات الاجتثاث وحل الجيش، فلم تمنح لهم الفرصة لقول رأيهم أو حتي لطرح أسئلة. ويقول وودوارد:
لم يستشر الجنرال مايرز وهو المستشار العسكري الرئيسي لبوش ورامسفيلد ومجلس الأمن القومي، في مسألة حل الجيش العراقي. وإنما قدمت له كأمر واقع.
وقد قال رامسفيلد لمايرز مرة:«لن نجلس هنا نحاول أن نتكهن بما يفعله» مشيرا إلي قرارات بريمر.
وقال مايرز لزميل له «لم أصوت علي هذا القرار ولكن أتفهم كيف تصور السفير بريمر أن هذا قرار معقول».
وطالما أنها القوات العراقية الغاضبة والعاطلة («لماذا يعاقبنا الأمريكان في حين أننا لم نقاتل» كما قال لي جندي سابق في أكتوبر) هي التي ستقتل جنود مايرز بعد أيام قليلة من صدور القرار بنيران القناصة والعبوات الناسفة الأولي، يمكن للمرء أن يري في كلمات الجنرال المتسامحة كرما غير مألوف.
في ذلك الوقت كان مدنيو البنتاجون قد حققوا اعظم سطوتهم وهيبتهم. كانت مؤتمرات رامسفيلد الصحفية اليومين تذاع حية في كل قنوات الأخبار، مع جمهور من الصحفيين يقهقهون علي نكات الوزير. ولم يبد علي أي منهم في حينها الشك فيما يسميه وودوارد «استهانته بالروتين الحكومي»، بل علي العكس كما يقول وودوارد:
من أبريل 2003 قرع الطبول المستمر الذي كان يسمعه هادلي من البنتاجون كان «هذه المسألة تخص دون رامسفيلد وسوف نقوم بقضية تسلسل الروتين الحكومي في بغداد. لنترك جيري يقوم به».
ويمكن القول أن «جيري» عند هذه المرحلة كان رجلا حسن النية ولكنه لم يتول مسئولية شيء في حياته اكبر من سفارة الولايات المتحدة في هولندة حيث كان سفيرنا هناك. ولم يكن يتكلم العربية ولا يعرف إلا القليل عن الشرق الأوسط ولاشيء عن العراق. ولم تكن له علاقة بالتخطيط الهزيل والسيئ الذي قام به البنتاجون لما بعد الحرب وبالتأكيد لم تمنح له سوي بضعة أيام للتحضير قبل شحنه إلي بغداد. ومن الواضح انه لم ير الخطط المفصلة التي رسمتها وزارة الخارجية لفترة ما بعد الحرب. وكما سيتضح مع مرور أيام الاحتلال انه قد اصبح اكثر اعتمادا علي مدنيي البنتاجون. ولم تكن لديه المؤهلات اللازمة لتنفيذ قرارات بهذه الضخامة، قرارات سوف تطيل أمد الاحتلال الأمريكي وستكون السبب الكبير في كتابة
«قال رامسفيلد فيما بعد انه كان سيدهش إذا عرف أن وولفوفتز وفايث هما اللذان أعطيا بريمر قرارات الاجتثاث وحل الجيش. وقال انه لا يتذكر اجتماعا في مجلس الأمن القومي حول الموضوع، وعن بريمر، قال رامسفيلد إنه لم يتكلم معه إلا نادرا».
من الصعب تصديق حتي في هذه الإدارة أن بريمر قرر من نفسه وفي يومه الثاني في بغداد حل الجيش العراقي ومن غير المحتمل أن ينسي رامسفيلد مسألة بهذا الحجم إذا كان قد تورط فيها، ولكن بالنسبة للمحارب البيروقراطي الماهر خاصة ذلك الذي لا يراقبه الرئيس أو الكونجرس، فإن ما يسميه وودوارد «عارض القفاز المطاط - أي الميل إلي عدم ترك بصمات علي القرارات» - يمكن أن يفيد في تفادي المسئولية - بعض الوقت - عن الخراب الذي تسببه تلك القرارات. ولكن هذا لا يمكن أن يمنع الآثار علي الأرض كما حدث في العراق.
بعد أربع سنوات من حرب العراق وبدخولنا «زمن الحلول المقترحة» تحدد نتائج تلك القرارات المبكرة شكل المشهد الدموي. بحل وإذلال جنود وضباط الجيش العراقي، فعل قادتنا الكثير لتجنيد الناس في ( التمرد) وبالاستعانة بجنود قليلة لتأمين مخازن السلاح الهائلة لصدام، ساعدوا علي تسليحه. وبالاستعانة بقوات قليلة لحفظ النظام، تفرجوا علي النهب والعنف الكاسح وتفكك المجتمع الذي قدم للتمرد أرضا خصبة. وفي تطهير عشرات الآلاف من الصفوة البعثية في البلاد مهما كانت أفعالهم، وبإقامة احتلال أمريكي يستعرض عضلاته بدون «وجه عراقي» خلقوا عداوة متزايدة بين العراقيين الذين تبنوا (التمرد) وشجعوا الناس علي رعايته وحمايته. وبتوفير القليل جدا من القوات لحماية حدود العراق ساعدوا في تدفق أعداد لا تنتهي من الأصوليين الإسلاميين من الدول المجاورة.
بالنسبة للأمريكيين الآن يبدو أن الوقت صار متأخرا جدا في العراق. ومعظم الأمريكيين الذين أرهقتهم الحرب التي فقدت مبررات وجودها، لا يريدون شيئا أكثر من بيان طريق الخروج. وقد بدأ الرئيس ومستشاروه حتي في الأسابيع التي سبقت الانتخابات يعيدون تعريف فكرة النصر، بتخفيض سقف أهدافهم المذكورة في القرار الرئاسي للأمن القومي في أغسطس 2002 . وهكذا فإن نائب الرئيس تشيني حين سئل قبل أسبوع من الانتخابات عن استراتيجية الخروج من العراق، أعلن أننا لا نبحث عن استراتيجية للخروج وإنما عن نصر ثم مضي يقدم تعريفا متواضعا للنصر:
«النصر هو اليوم الذي يحل العراقيون مشاكلهم السياسية ويستطيعون إدارة حكومتهم وحين يتمكنون من توفير أمنهم بأنفسهم».
هذا كان قبل أن يذهب الأمريكان إلي صناديق الاقتراع ويدينون بنسبة كاسحة سياسات الإدارة في العراق، حيث كانت النتيجة كما عبر عنها أحد الكوميديانات «في ليلة الثلاثاء، حصلت مفارقة عجيبة، لقد غير العراق نظام الولايات المتحدة». وبعد يوم من الانتخابات تقدم الرئيس الذي سلبت منه أغلبيته في الكونجرس، بتعريف اكثر تواضعا: النصر يعني إقامة «حكومة عراقية تستطيع أن تدافع وتحكم وتحافظ علي نفسها».
وفي الحقيقة، حتي هذه الكلمات المتواضعة تبدو طموحة جدا وبعيدة عن الواقع. وبينما اكتب هذا، فشلت عملية «معا إلي الأمام» المشتركة بين القوات الأمريكية والعراقية لتأمين مدينة بغداد. وقد جابه القائد الأمريكي في العاصمة زيادة 28% في الهجمات خلال العملية أعلن أن النتائج «محبطة» وحسب المعلن من الخطاب العسكري المتعارف عليه، لم يكن من الممكن - قبل سنة - أن يصدر مثل هذا التصريح من ضابط أمريكي برتبة عالية.
وكان الغرض من (عملية معا إلي الأمام) ليس فقط إيضاح استعداد العراقيين للدفاع عن أنفسهم كما وصفها الرئيس ولكن لتمكين «حكومة الوحدة لإصدار قرارات صعبة وضرورية لتوحيد البلاد». كان من أهداف العملية ثلم قوة المتمردين السنة وبهذا يفسح الطريق لرئيس الوزراء نوري المالكي لدعم نزع سلاح المليشيات المسئولة عن الكثير من قتل فرق الموت في بغداد. لسوء الحظ، تلك المليشيات - علي الأخص جيش المهدي ومنظمة بدر - تبقي جزءا مهما من البني التحتية السياسية في حكومة الوحدة. وهذه الحقيقة السياسية المزعجة ولكن الأساسية تجعل من كثير من خطاب إدارة بوش حول استراتيجيتها الحالية في العراق مجرد هراء. إن التناقض الواضح بين السياسة والواقع وردود الأفعال الغاضبة من المالكي علي جهود الجيش الأمريكي لكبح جماح الميليشيات بشن هجمات في مدينة الصدر، حركت شائعات في بغداد وواشنطن باحتمالية حدوث انقلاب بعد الانتخابات لاستبدال المالكي بحكومة إنقاذ وطني. ومن الصعب التكهن بما تستطيع أن تحققه مثل هذه الحكومة - سواء رأسها إياد علاوي وهو المفضل لدي واشنطن وقد عمل رئيس وزراء مؤقت لفترة قصيرة (والذي يخشي أن يأتي إلي السلطة عن طريق انقلاب) أو أي شخص «قوي» آخر. أو أي مكاسب سوف تتحقق للأمن مقابل الثمن السياسي الفادح للإطاحة بحكومة (منتخبة) مهما كان ضعفها. إن إقامة تلك الحكومة يظل واحدا من الإنجازات القليلة (المشكوك بها) من البرنامج الأصلي للعراق.
بالنسبة للشعب الأمريكي تبدو حرب العراق قد دخلت فصلها الثالث والأخير. رغم أن الخطط والأفكار سوف تأتي الآن سريعا وكلها موجهة للإجابة علي سؤال واحد مهيمن «كيف نخرج من العراق؟» - ولن تتضمن أي من الإجابات وسيلة للانسحاب بدون دفع ثمن باهظ جدا. إن الإحساس الذي يسود حاليا بالنهاية فيما يخص العراق تكمن جذوره في إعياء وإحباط الأمريكان اكثر منها محاولة جادة للبحث عن «حل» أو «استراتيجية للخروج» دون أن تبدو علي حقيقتها وهي الاعتراف الصريح بسياسة فاشلة وحتي كارثية.
قبل أسبوع من الانتخابات حذر الرئيس بوش أحد المتحاورين معه حول نتائج الهزيمة الأمريكية في العراق:
الإرهابيون.. قالوا بوضوح إنهم يريدون ملاذا آمنا لشن الهجمات ضد أمريكا، ملاذا آمنا يستطيعون منه الإطاحة بحكومات معتدلة في الشرق الأوسط، ملاذا آمنا ينشرون منه أفكار الجهاد والتي تقول بعدم وجود حريات في العالم وأننا نملي عليكم ما تفكرون.. أري بوضوح عالما أري فيه الأصوليين والمتطرفين يسيطرون علي البترول. وسوف يقولون للغرب: إما تتخلون عن إسرائيل، مثلا، أو سوف نرفع سعر البترول.. أو انسحبوا..
وبعد أيام من هزيمة الجمهوريين في الانتخابات قدم جوش بولتون رئيس موظفي الرئيس وهو يناقش الحكومة العراقية، المسألة بوضوح اكبر:
نحتاج لمعاملتهم كحكومة ذات سيادة. ولكن نحتاج أيضا لإعطائهم الدعم الذي يحتاجونه لأن البديل للولايات المتحدة كما اعتقد سيكون كارثيا بحق... يمكن أن نترك خلفنا عراقا فاشلا، ملاذا للإرهابيين، يمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة والمنطقة وهذه نتيجة غير مقبولة.
ونحن في طريقنا إلي تحقق هذه الرؤية القاتمة، موجة من اللااستقرار الخطر تلتطم من الاتجاه المعاكس مع أمواج «تسونامي ديمقراطي» التي وعدت إدارة بوش أن تنطلق كثورة تحرر في أرجاء الشرق الأوسط اثر غزوها العراق. إن فرص إنجاز مثل هذا التغيير داخل العراق نفسه، ناهيك عن مشهد معقد علي امتداد منطقة كاملة، كانت ضئيلة دائما. إن صدام حسين والاوتوقراطية التي كان يحكمها كانت نتاج سياسات غير فاعلة وليست سببا لها. وإصلاح مثل هذه السياسات كان مهمة تتضمن الكثير من التعقيد غير المحسوب. وحين جوبه الرئيس ومستشاروه بهذا التعقيد وبسبب تصميمهم علي شن الحرب وثورتهم الديمقراطية، أشاحوا عنه. وحين جوبهوا بمزيد من المصاعب كان جوابهم هو إغماض أعينهم والتمسك بالأيديولوجية والأمل - حالمين بمشهد ودود ومتغير بعصا سحرية. إن الرؤية الإنجيلية قد تكون جعلت الإحساس بالخطر بعد 11/9 أسهل احتمالا ولكنها لم تغير المخاطر والواقع علي الأرض. والنتيجة أن موجة التغيير التي كان الرئيس وموظفوه عازمين علي إطلاقها بواسطة القوة العسكرية الأمريكية ستكون في النهاية هي ذاتها موجة الأصولية الإسلامية التي كانوا يأملون في القضاء عليها.
في الأسابيع القادمة سوف نسمع الكثير من الأحاديث حول «استراتيجية الخروج» و«الحلول المقترحة». كل مثل هذه «الحلول»، علي أية حال، سوف تتضمن ثمنا سياسيا باهظا، ثمنا قد يعتبره الرئيس أصعب علي الاحتمال من ثمن «الاستمرار في النهج» لبقية فترته الرئاسية. ولا يمكن أن يكون جورج دبليو بوش - الذي تعهد في حملة رئاسته الأولي أن يولي عناية متواضعة للسياسة الخارجية - قد توقع كل الذي حدث. وقد قالها كينان في أكتوبر 2002:
«كل شخص درس تاريخ الدبلوماسية الأمريكية خاصة الدبلوماسية العسكرية، يعرف انك قد تبدأ الحرب بأشياء في رأسك كمبرر لما تفعله، ولكن في النهاية تجد نفسك تحارب من أجل أشياء مختلفة لم تفكر بها سابقا. بكلمات أخري إن للحرب منطقها الخاص وهي تحملك بعيدا عن كل مقاصدك التي فكرت بها حين بدأت الحرب».
إذا كنا فعلا في الفصل الثالث، كما سأتناول في مقالة قادمة - فمن المحتمل أن يكون هذا الفصل النهائي طويلا جدا ومؤلما جدا. قد تعرف أو لا تعرف أين تبدأ ولكنك لن تعرف أين تنتهي.
الحرب الحقيقية الناجحة مات فيها 140 أمريكيا وفي مرحلة ما بعد الحرب مات 2700 أمريكي - والعدد يتصاعد.
كيف حدث أن هذا العدد الكبير من المسئولين ذوي الدراية والخبرة والذكاء اجتمعوا علي أخطاء هائلة ومؤثرة وفوق كل شيء واضحة
سيكون النصر سريعا وصادما وفي اشهر قليلة، سوف يخرج الأمريكان إلا حفنة منهم: ولن يبقي من آثار الحرب سوي «الأمثولة» والتأثيرات علي الدول المجاورة.
أضاعت الحرب «احتواء» العراق الذي لم يكن تهديدا لأحد سوي في مخيلة صناع السياسة، فالبلاد اليوم تهديد بتدفق الجهاديين من القوي المجاورة
يدعو الكثيرون لتقسيم العراق بسبب اليأس عن إيجاد «حل» حتي لو كان وهميا للحرب.. أي شيء يسمح للأمريكان بالانسحاب بدون الاضطرار للاعتراف بالهزيمة.
جزء من سبب غياب التخطيط لعراق ما بعد صدام هو أن وزارة الخارجية كانت تقول إذا غزيتم يجب أن تكون لكم خطة ما بعد الحرب، ووزارة الدفاع تقول: كلا.. لا حاجة.
رغم جاذبية رامسفيلد كشرير الأحداث فإن قصة كارثة حرب العراق تنبع بنفس القدر من أفعال رئيس عنيد وصعب المراس وقليل الخبرة
لم يحسب حساب المعاني السياسية لقراري الاجتثاث وحل الجيش فقد بدا الأمر للسنة علي أنه إعلان حرب مفتوحة ضدهم